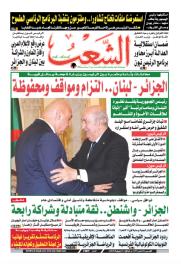نعني بـ «الهُويّة» هنا ليس الانتماء الدّيني للفرد والمعتقد الذّاتي أو الّلغة التي هي عناصر التّعريف بالشَّخص أو الأمّة، ولكن «التّصورات والسُّلوك الجماعي في العلاقة مع الله والحياة والموت تأخذ تعبيراً عنها باللغة الكلاميّة والرّمزيّة»، وهي ليست «هويّة إداريّة» أو «هويّة نتعلّمُها» أو لها كَهنتها كما يحاول بعضهم الوصاية واحتكار التأويل الخاصّ به، ولذلك كلّما حاولنا توجيه الآخرين في قضايا الهُويّة يكون الاختلاف والشِّقاق لأنّنا لا نفرّق بين ما يسمّى عناصِر الهُويّة مثل الدّين واللغة والوطن التي هي ذات طابع قانوني وإداري وأخلاقي، والهُويّة التي أشرت لها سَالفاً، كما أنّنا لا نفرِّق بين «الهُوية السّيّادية» التي لها علاقة بشخصيّة الأمة أو الدّولة القائِمة، والانتماء لمجموعة رموز أو «القِيم الضّابِطة المشتركة» التي تخضع للسّيرورة الاجتماعية والميراث المشترك الذي يتكيّف بعضه مع العصر الذي يعيش فيه، فمنه من يستمرّ معنا وآخر يزول ويتلاشى، لكن السّمة الأساسيّة التي تتميّز بها «الوجدانيّة» أي أنّه «سلطة بسيكولوجية-اجتماعية» تصنع وعياً تُجاه العلاقة مع الدّين والآخر، وحتى لا يفهم القارئ أنّ الهُويّة ذات طابع سرمدي ثابت بل هي في تغيّر ويكون للثّورات العلميّة والمعرفيّة والسيّاسية الأثر في مضمونها وتعبيراتها الرّمزية، وهذا حسب الخِلاف والتّمايز بين الشّعوب، فالدّين مثلا موقعه عندنا جوهري أما بالنسبة لليابانيّين والصينيّين فهم يتحدّثون عن «الحَضارة»، وبالتالي الإصلاح عندهم حضاري وليس منوطاً بالمسألة الدّينية، كما أنّ الدّولة عريقة في كلّ من الصّين واليابان وليس لهم مشكل مع الدّولة الوطنيّة كما هو الشّأن عندنا (راجع كتاب «أفكار مهاجرة» لعلي أومليل)، وهكذا سوف تكون العلمانية في فرنسا في صدام تاريخي مع الدّين وتتحول «العلمانية إلى دينٍ جديد» فهي الهُويّة الرّسميّة التي تسعى لإيجاد ترسانة قانونية جديدة لتصبح هويّة المجتمع الفرنسي، ونحن بذلك قد نقصد بها أيضا «الثّقافة» التي هي بمعنى ماكس فيبر «شَبكات رمزيّة» عالقٌ بها الإنسان، نسجها بنفسه حول نفسِه، وتحليلها لا يجب أن يكون علما تجريبياً يبحث عن قانون بل علماً تأويلياً يبحث عن معنين: أي البحث عن الشّرح: شرح التعبيرات الاجتماعية، وإجلاء غوامِضها الظّاهرة على السّطح، أي القيام بالتأويل كما يرى الأنثروبولوجي كليفورد غيرتز (Clifford Geertz).
سُقنا هذه المقدّمة لنرى إلى أيِّ مدى تُؤثِّر الجَوائح على «الرّمزيات المشتركة»؟ في بقاء وزوال بعضها؟ وما هي المضامين التي نعيد بها قراءة «الهُويّة»؟ وهل يصبح «القوْل الطّبي» هو الفيصل أم «القوْل الدّيني» و»العادة الاجتماعيّة»؟
الجَائحة وسُؤال الوُجود؟
ستكون لـ «جائحة كورونا» إذا أحدثت المأساة السيناريو المحتمل بداية مرحلة جديدة للبشرية في تجديد أسْئلتها الوجودية والدينية والأخلاقية، وأنظمتها الاقتصادية والسّياسية وإعادة خريطة العلاقات الدّوليّة، وربما سقوط أنظمة مثل الأنظمة العربية التي ستعاني من موجة ربيع جديدة ترتبط بالجَائِحة، وبعد تداول أخبار إعلان حالة الطوارئ في بلدان قوية ومتقدمة مثل الولايات المتحدّة الأمريكية، فإنّ هذا يعني زعزعة الثّقة في المنظومة الصّحية وزعزعة الثّقة في العلاقة بين الشعوب وحكّامها، وتعيد الدّولة الحديثة مَركزيّتها ولكن عبر «النّظام الرّقمي»، الذي أصبح بديلا عن الذّهاب إلى الشّغل والذي هو مُتخلّف في بلداننا العربية، ولم تنتبه لأهميته بل كانت تخاف منه السّلط العربية لأسباب أمنية وسياسية.
كما أنّ الزّلزال لن يكون فقط في طبيعة السّلطة والعلاقات الدّوليّة والاقتصاد ولكن في العلاقات الإنسانية ذاتها ستختفي سُلوكات وتنشأ سُلوكات وذهنيّات جديدة.
منذ بداية الكوفيد 19 ظهرت مجموعة من الدّراسات الاجتماعية والفلسفيّة والسّياسية التي تُحاول فهم أثر الجائِحة على أسئلة الوجود الفلسفيّة والصّراع السّياسي، ومن سيقود العالم بعد الوباء الجارف هل الصّين أم الولايات المتحدّة الأمريكية؟ فقد برز الخلاف السّياسي للسّطح بين القوّة الآسيوية والقوة الغربية، كما استغلّت إيران الوضع الصّحي لديها لنقد قرار العقوبات الاقتصادية، ورأى آخرون أنّ الجائحة ستكون وبالاً على الحريّات الفرديّة والجماعيّة، فتاريخ البشريّة يتأسّس من جديد بعد الكوارث الكُبرى كالحُروب والأوبئة والمجاعات والزّلازل، ونقصد هنا بإعادة التّأسيس على مستوى بِنية السّلطة والعلاقات الدّولية أولاً ثم على مستوى العقائد ورُؤية الحياة والكَون، والفلسفات التي تسأل عن قَضايا الوجود والمصير الإنساني كانت أسئلتها بعد رؤية مشاهد الموت أو الحَكْي عنه، ولذلك بعض مُؤرّخي الأديان لا يَغرقون في النّصوص ولكنهم يبحثون التّاريخ البشري مثل تاريخ الموت بفعل الحُروب والأمراض والكوارث، وحتى «الدّيمغرافيّة التّاريخيّة» كعلم يبحث في الأستوغرافيا عن إعادة تشكيل خَريطة السّكان وأثر ذلك على البِنية الاجتماعية والتّصورات والمعتقدات، وقد تنبّه الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو في بحثه عن تَشكُّل السّلطة في الغرب من خِلال نظام «الكرنتينية» الحَجر الصّحي وإجراءات العزل، واعتبرها المَرجعيّة النّظرية والتّطبيقية مثل السّجون والمِصحّات النفسية لتأسيس السّلطة والمجتمع الانضباطي في القرن السّابع عشر، وهذا القرن خُلاصة ما مرّت به أوربا منذ القرن الرابع عشر من أوبئة طاعونية جَارفة، كما أنّ الفلسفة الوجودية التي تتعلّق بسُؤال الدّين والحريّة والوجود والخوف والحبّ والمصير ازدهرت بعد الحرب العالمية الأولى والثانية في القرن العشرين، وكان من أوَائل مُؤسّسيها مارتن هايدغر صاحب تُحفة «الكينونة والزّمان»، الذي حاول من خلال إعادة فهم الإنسان في الوجود، فهم كينونته متحرّراً من التصورات السّابقة واستعاض عن المفاهيم السّابقة بمفهوم جديد يعبّر عن فكرته «الدّازين»، وكان سارتر مُرعَباً من الحرب في الجزائر فكتب «عارُنا في الجزائر؟» لأنّ الحرب تعني ضدّ الوجود الإنساني الذي معناه «الحريّة»، فالكائن ليس حيواناً لغوياً ولكن مِيزته «الحُريّة»، كما أنّ اضطهاد اليهود كان مأساة لبعض فلاسفتهم فكانت مفاهيم «الآخر» و»العِرق» و»التّسامح» و»الحوار» موضوعات جوهرية في كتبهم مثل لوفيناس، الذي أعاد معاني «الوَجْه» الإنساني ليس كجزء بيولوجي، ولكن كتعبير عن العلاقة مع الآخر وبناء العواطف المشتركة.
هل هناك عودة للرّوحانيات؟
رأى إدغار موران أنّ كوفيد 19 معناه اللاّيقين، لأنّه كشف عن غرور الإنسان وعجز الطبّ، ولذلك سنكون أمام إخفاق «اليقين» سواء في العلوم أو السياسية أو الدّين، وهذا الاتجاه يتساوق مع التهليل الذي تابعناه منذ سنة تقريباً في نقد النيوليبرالية وبعض هؤلاء خصوصاً من اليساريين والبيئيين يبحثون دوماً عن ما يبشّر بسقوط الرأسماليّة، وهو خطاب مهدوي يبحث عن أشكال جديدة من الاقتصاد والسياسة أكثر إنسانية وعدالة، كما أن دعوة ما بعد الحداثة هي في صميمها ضدّ اليقين والمركز والثنائيات التقليدية في الفلسفة، وهذه الدعوات تلتقي مع التيارات الدينية سواء في المسيحية أو الإسلام المعادية لتوغّل الماديّة الغربية وانحرافاتها، ولذلك يتلقف بعضنا مثل هذه الدعوات ليطمئنّ أنه على صواب في وصف الحضارة الغربية بالغيِّ والزّيف، كما أنّه في بداية الجائحة لم تتهم الصين فقط من طرف البيت الأبيض من خلال الرئيس دونالد ترامب علىى أنّها مُؤامرة صينيّة للهيمنة على العالم بل هناك من ربط ذلك باللا إيمان عند الصينيين أو بالاستهزاء بما يأكلون ويعتقدون، وبعضهم الآخر ربط ذلك بالسّخط الإلهي وبغضبه من الإنسان الذي هو خليفة الله في الأرض، وهي مسائل تعيد القديم - الجديد حول علاقة الانسان بالله في الأديان، وهل نحتاج إلى تأويل سَليم لهذه العلاقة ليس في الإسلام فقط ولكن أيضاً في الأديان الأخرى.
طبعاً بعد كل جائحة أو كارثة يكون الدّين حاضراً، ويختلف هذا الحُضور والعودة إلى الرّوحانيات في الأزمنة التّاريخية، قد يكون بوعي فنكون أمام تأويلات جديدة أو بنكوص خرافي يستقيل فيه العقل ويُدَمّر المستقبل، فجوائح شمال إفريقيا في القرون الأخيرة جعلت سَرد الكرامات الصُّوفيّة تتجاوز حدود الخيال ومعجزات الأنبياء وارتبطت في الغالب بتفجير ينابيع المياه في غياب الغيْث واستمرار القحط، كما كان البُرء من الأمراض بتدخّل الصّالحين وزيارة أضرحتهم في أزمنة انتشار الكوليرا والطّاعون، وهذه العلاقة السّحرية مع الجوائِح تعرفها عديد المجتمعات في حال العجز والمآسي الكبرى التي تتحدّى القُدرة البشريّة. وفي قرننا هذا ننتظر الّلقاح ونسمع لقرار الطّب، ويكون هو مصدر القرارات السيّاسيّة والفتاوى الدّينية، وهذا تحوّل علمي وفي الوعي الإنساني سيعمل على تقويض الخُرافة أو الحدّ منها، كما يُعطي الثِّقة في العلم إذا ما توفّر اللقاح، وهناك تكون العودة إلى الرّوح بوعي وبكون رحمة الله تسع الجميع، وأنّ العلم واستعماله في مصلحة الإنسانيّة هو عبادة أيضاً ويُثاب عليها، لأن العقل هو المعنى من قوله تعالى ﴿إنِّي جاعلٌ في الأرض خليفةً﴾، فهذا معنى الخلافة وهو أن نحافظ على الجنس البشري بالعلم والسّلم، وهي مقاصد شرعية حفظيّة للحياة والدّين، بمثل هذه القيَم القديمة –الجديدة سنكون أمام هُوية تتجدّد وتأخذ أشكالاً جديدة، فالاهتمام بالعلم والعمل الخيري ورؤية الآخر كصديق والتعاون الإنساني هي أيضاً «هُويّة عصريّة» يساهم الدّين في تشكيلها والوعي بها بفهم لروح القرآن الكريم والسّنّة النبويّة، بهذا المعنى أتصور أنّ العودة إلى الرّوحانيات قد تكون بوعي وبفهم جديد كما قال الأمير عبدالقادر في كتابه التّأملي: «المواقف» «الفهم الجديد للدّين التليد»، ولأن «التأويليّة» في العلوم الاجتماعيّة هي اللغة المشتركة في عصرنا، وبالمعنى النيتشوي «كلُّ شيء عرضة للتّأويل»، وبالمعنى الأفلاطوني: «لا وجود لوقائع، لا وجود إلاّ للتأويلات» لأنّنا كائنات نعيش كلّياً في عنصر المعنى الذي لا يمكن تجاوزه، المعنى الذي نجهد لفهمه والذي نفترضه ضرورة، والمعنى هذا هو معنى الأشياء بالذات (L’herméneutique, By Jean Grondin)، المعنى الذي يتجاوز تأويلاتنا الفقيرة بالأفق المحدود، وهو يمتدّ بامتداد لغتنا التي هي أيضاً تعبير عن هُويّتنا وقِيمنا المشتركة.
الجائِحة والفُقهاء
في تاريخنا الإسلامي ضَرب الطّاعون زمن الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سنة 18هـ بلدة عَمواس بعد فتح المقدس وهي قريبة منه، ومات فيه ثلاثون ألف في الشام، ومن أبرزهم من الصّحابة: أبوعبيدة بن الجراح، ويزيد بن أبي سفيان، وسهيل بن عمرو، وهو العام نفسه الذي كانت فيه المجاعة الشّهيرة، هذه الكارثة الوبائية والغذائية كانت بداية استنباط الأحكام العقائدية في قضايا القَدر والمصير الإنساني، وهل نعتبر الذين ماتوا فيه شهداء أم لا؟ وكنّا أمام خُطبتين من قياديين صحابيين مختلفتين في المضمون، فقد خَطَب القائد معاذ بن جبل بحمص الشام فقال: «إنّ هذا الطّاعون رَحمة ربّكم ودَعوة نَبيّكم ومَوت الصّالحين قبلكم، الّلهم أقسِم لآل معاذ نَصيبهم الأوْفى منهم»، وكان أوّل ضحاياه، وبعده خَطب عمرو بن العاص مخالفاً له فقال: «أيّها النّاس إن هذا الوَجَع إذا وقع فإنما يَشتعل اشتعال النّار فتجَبَّلوا منه في الجبال»، فخرج بالنّاس إلى الجبال، ورفعه الله عنهم، ولم يكره عمر بن الخطاب ذلك أو اعتبره فِراراً من القدر، وقد سقطت أنظمة في المغرب الأقصى بفِعل الأوبئة والمجاعات والجوائح في القرون المتأخرة.
وحتى الممارسة الدينية سيطرأ عليها بعض العادات، ويصبح تحبيذ فقهائنا في صَبْغ الوضوء سُلوكاً حميداً مطلوباً من الجميع ولكن مع المُطهّر الكحولي في مِيضات المساجد، ستكون فوبيا النّظافة الدائمة في البدء ثم تَصير سُلوكاً، كما أنّ «العلاقة الإنسانية - المِتريّة»، والقَصد هنا «مسافة المتر» بينك وبين الآخر هي المُحدّدة وتختفي العادة الاعتباطية للمصافحة والتقبيل، وتكون محدودة جداً.
سيكون ذلك أيضاً رَحمة علينا إذا استطعنا رفع شِعار «رُبّ ضَارّة نَافِعة»، فنُحارب التّبذير والفوضى في التسيير الاقتصادي ونُبطل عادات مازالت تمارسها السّلطة في إحداث هياكل ومؤسسات لا فائدة منها، ونُراجع وجُود مؤسّسات جمهورية تُرهق ميزانية الدّولة في الدستور الجديد، ونُدخل في دفتر الشّروط موادّ جديدة في بناء المجمّعات السّكنية ودور العبادة ووسائل النّقل، ويُصبح شِعارنا «النظّافة هي الحياة» في مجتمعات مازالت تبصق في الشّوارع وترمي أوساخها جَهْرة وتغيّر من نفسيّة اللامبالاة والاستهتار بالحياة.
إنّ القول بالعدوى وما أثاره من تأويلات وخِلافات فقهيّة انتصرت فيها رأي أن العدوى ممكنة وليست قدراً حتمياً يصعب مواجهته، فالحديث الذي ظلّ مروياً عن البخاري ومسلم لقرون «لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة»، وقد حصره بعضهم في سعي الإسلام إبطال معتقدات عند العرب قبل الإسلام، وبالتالي هو ليس نفياً للعدوى ككل ولكن نفياً لفهمها كما اعتقد العرب، أي أن الأشياء تؤثّر في بعضها دون تدخل الإرادة الإلهية، في حين استند فقهاء آخرون إلى أحاديث عدوى الجُذام عن طريق المماسة والمخالطة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد» مسند ابن حنبل (رقم 9345)، وحديث «لا يُوردُ مُمْرض على مصحّ» مسلم (رقم 4117)، والخِلاف سواء حول الأحاديث وسياقاتها التاريخية والاجتماعية تتعلّق بقضايا عقدية في تأثّر المرض بذاته أم بقدرة الله، وقد فصّل في الأقوال المتعلقة بالأوبئة والطاعون من الفقهاء المتأخرين إبن خاتمة في كتابه: «تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد»، كما أن ابن عرفة معاصر ابن خلدون وامام جامع الزيتونة رفض أن يدرس ويلتحق بالمسجد في الطاعون الجارف سنة 1348.
هذا الخلاف الفقهي الذي نقرأه في نوازل الفقهاء ظهر بشكل آخر في وسائط التواصل الاجتماعي، ولكن كانت فتاوى المجامع الفقهية تقريباً متّحدة في مسائل غلق المساجد وتعطيل صلاة الجمعة والتباعد في الصّلاة، والتغيير الذي حدث في دفن موتى الكوفيد 19، كما كانت مبادرة «الصّلاة من أجل الإنسانية» التي أطلقتها «اللجنة العليا للأخوة الإنسانية» استجابة من هيئات وقيادات دينية، وهذا اللقاء بين الأديان في التوجّه إلى الله لرفع الوباء ذكّرنا بما حدث في دمشق زمن طاعون عام 749هـ، فقد تحدّث ابن بطوطة في رحلته أنّ أمير المدينة أمر بخروج المسلمين واليهود والمسيحيين للتضرّع والدّعاء، فصام المسلمون ثلاثة أيّام، ثم اجتمع الأمراء والشّرفاء والقضاة والفقهاء في الجامع الأعظم، وباتوا ليلة الجمعة بين مصلٍّ وذاكرٍ وداعٍ، ثمّ صلُّوا الصّبح وخرجوا مشياً وبأيديهم المصاحف والأمراء حفاة، وخرج جميع أهل البلد، وخرج اليهود بتوراتهم والنصارى بإنجيلهم، وصار التجمع للدعاء لرفع الوباء تقليداً، وأنكره ابن حجر العسقلاني واعتبره بدعة في كتابه «بذل الماعُون في فضل الطّاعون» كان هو ضحية الفاجعة إذ توفيت بناته بسبب الطّاعون.
تجاوز هذا الخِلاف الفقهي التقليدي في قضايا الأوبئة والجوائح كان بسبب الإيمان بما يقوله العلم، وهنا انتصار علمي نسبي في كون الفتوى تخضع إلى قول العلم (بيو-فقيّة) ولو أن منهجا استدلالها يبقى خاضعاً للرؤية الأصولية التّقليدية مع الحريّة في التنقل بين المذاهب الفقهية، وعدم الالتزام في النوازل بمذهب واحد، وقد كان مؤتمر «فقه الطّوارئ: معالم فقه ما بعد الكورونا»، الذي نظّمه افتراضياً رابطة العالم الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء الشّرعي، ممّا سيعزّز الإفتاء الجماعي، وتحقيق التعاون مع الاختصاصات العلميّة الأخرى، وهذا من حسنات كوفيد 19.
تلكم الأسئلة والاستنتاجات تبقى مفتوحة أمام استمرار هذه الجائحة، وسيكون للقرارات والتغيير العالمي في مجال السياسة والاقتصاد تأثيراً بالغاً في الهُوية، وتشكّلها واستمرار عناصرها ومميزاتها، لكن يبقى الدّين واللغة والقيم المشتركة، ويكون التعبير والتأويل والاجتهاد هي مجالات مفتوحة وثرية للمسلمين والبشريّة جمعاء.
مجلة «فواصل» - العدد التّجريبي